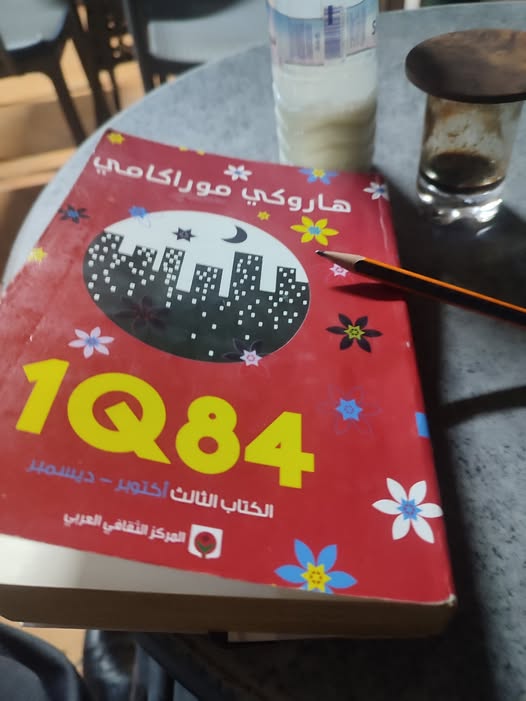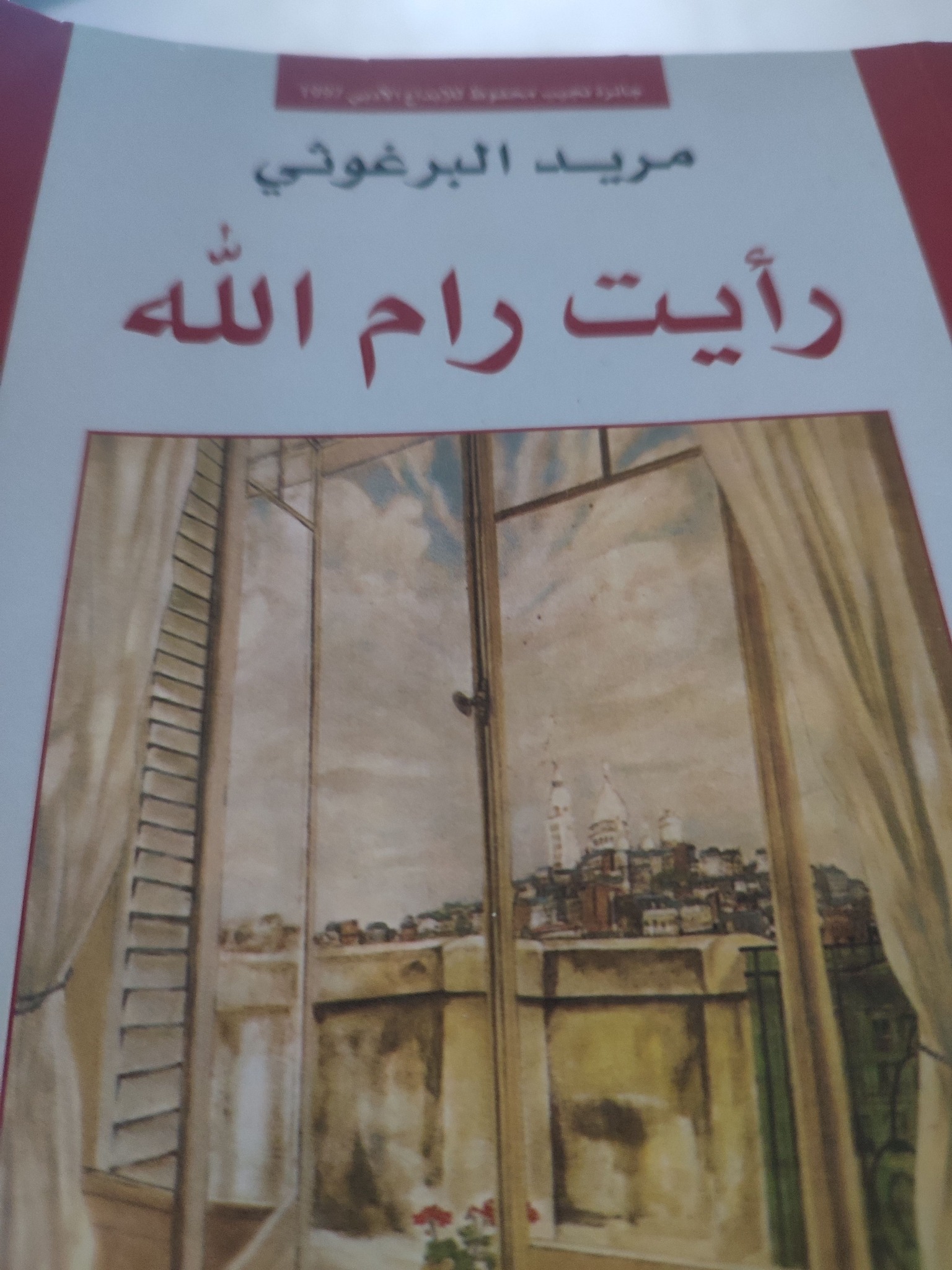فعلا،الكتابة ليست بحلم وردي من أحلام الوسادة،سرعان ما يكذبه الواقع عند لحظة الاستيقاظ،بل هو زبدة عمر من المطالعة و القراءة لنصوص عالمية مؤسسة للأدب والفكر الإنسانيين و تؤسس بالفعل لكتابة تلوح في الأفق..
الكتابة الأخت الشقيقة للقراءة – بل هي التوأم لها- فإن مرضت الواحدة منهما أو تغير مزاجها أثرذلك على أختها ،لذلك من الأفضل أن تبقى قريبة منها لأنها نصفها الثاني ...
عادة ما نحمل معنا ذاك الطفل الصغير ولن يكبر أبدا وصدق جبران خليل جبران لما تمنى بأن يكون ببراءة ذاك الطفل الذي نحمل خياله بين طيات ذاكرتنا “ليتني طفلا لا يكبر أبدا فلا أنافق ولا أهان ولا أكره أحدا..
الشعراء والأدباء يتقمصون صورة ذاك الطفل البريء، لذلك نجد في كتاباتهم النصية ما دفن في ذاكرة الماضي من تلك المرحلة المهمة من حياة الإنسان..
وهو يافع.. وهو رجل.. وهو شيخ ..وهو هرم..
الشاعرة تورية لغريب ..اليوم طلت على قرائها في صورة من فيود باك ولبست ثياب تلك الطفلة الصغيرة التي لن تكبر أبدا بل ستبقى حية،وهي تحكي كل شيء من الماضي، و في سيرورة من سيناريو الحياة المقتبسة من الذاكرة الزمانية والمكانية والبصرية...
الطفلة التي لا تريد أن تكبر أبدا..تريد أن تختبئ تحت المائدة وتنتظر بلهفة العطلة كي تتحرر من رتابة دروس جافة، وقهر وتجبر معلم ، وفضاء مدرسة لا تذهب إليها إلا بأوامر أبوية وسلطة مجتمعية ..
- إنها الشاعرة التي تقمصت في نصها صورة الطفلة البريئة التي تعيش الخوف الوجودي في مجتمعها وبين مؤسساته “الأسرة و المدرسة ..”
- إنها الشاعرة في صورة المؤرخة التي تقوم بنقد ذاتي لواقع طفولة بئيسة تعيش أشكالا من أشكال التسلط والقهر بين عتمات واقع مظلم.
- إنها الشاعرة في صورة الأنثروبولوجية التي ترى بعيونها جيل من الإنسان المغربي وهو في صراع بين فكي وقمع كل ذي سلطان.
- إنها الشاعرة في صورة السياسية التي استعملت صباغة من ألوان السواد في مرحلة من مراحل الصراع في التاريخ السياسي المغربي المعاصر ثورة كوميرا كازابلانكا.
- إنها الشاعرة و الأديبة التي كتبت سيرة حياتها وهي تختار أصعب مرحلة فيها التي تعتبر القشة التي قصمت ظهر البعير في أوطان لا تعطي لطفولتها ذاك الحنان والاهتمام المستحق ..
وكلما مررت على نص من النصوص عبر عالم الفضاء الأزرق، ويكون بالفعل قد راقني، قد أقرأه من رأسه حتى أخمص قدميه. وأنصت لنبضات قلبه وأتفحص ملامح وجهه، كي نعيش معه لحظات تأملية جميلة، ونحن نستبر أغواره كي ندون في شأنه بعفوية وفطرة وحميمية عبارات من جمل ما فتئنا نطلبها عبر قراءاتنا الأدبية والفنية والفكرية والفلسفية..

أول الفصول في حياة امرأة :
ذاكرة الطفولة هي ما يصنع حاضرنا …حجرُ الأساس الذي يبني شخصية المستقبل، يدعونا لأن نُرهف السّمع، لكلّ ما ظلّ حبيس الجسد الغضّ…لا لنحاكم الماضي، بل لأنّه في التّعرّي أمام مرآة النّفس، شفاء لآثار السّقوط المستتر ونحن نتسلّق أدراج العمر…

مع أولى خطوات النّبش في ذاكرتي، أهوي في بئر من الأطياف الشّاحبة، تلك التي شكّلت ملامح تجربة التّمدرس؛ فضاء مدرسة ” الأخطل بنات” المقابلة لبيت نشأتي الأولى بجدرانها المائلة للّون الأصفر، ونوافذها المتكسّرة، أتذكّر اسم حارس بوّابة المدسة ” بّا علي ” كما كنّا ننادي عليه، رجل أسمر البشرة، كان يستفزّ ضحكاتنا البريئة، بحركاته البهلوانية، ونحن ننتظر صوت جرس الدّخول إلى الأقسام، وزوجته ” أمي فاطنة”، المرأة التي كنّا نهاب صوتها العالي…ربّما كان هذا هو الجزء المضيء من رحلتي المدرسيّة، وعلى النّقيض من ذلك، أحمل ذاكرة مشوَّشة عن باقي الشّخوص، فقد ترسّخت صورة الخوف وبرد الصباحات في مخيّلتي الصّغيرة، بدل صور المرح الّتي من المفروض أن تصاحب عادةً، هذه المرحلة العمريّة الأساسيّة، الحاسمة والمحدِّدة لِملامح شخصيّة المستقبل.
أتذكّر شكل المقاعد المهترئة، وذاك الشّعور بالهلع من المعلّم الذي يتقمّص دور (المْعَلَّم)، دون معرفة مسبقة بنظريات التّعلم والأسس النّفسيّة للأطفال، ذاك المعلّم، الذي تسيطر عليه الرّغبة في التّشرّب من الامتداد السلطوي، المهيمن على التفكير السائد آنذاك، المستنِد في شرعيّته على نماذج ممثّلي السّلطة بكامل أطيافها، في علاقتها بالبسطاء…
على السّبورة العتيقة، ترتعش أصابع التّلاميذ الصّغار وهم يخطُّون حروف الأبجدية تحت وقع السّياط، وكأنّهم معتقَلون في زنازين مخافر الشرطة، ورغم سقوط أسماء هذه الحِقبة القاتمة من ذاكرتي، إلاّ أنّني مازلت أذكر اسم المعلّم ” الرّعد” ، الذي كانت فونيمات اسمِه تدوّي في أذنيّ، قبل أن يرغي، يزبد، يرعد، ويبرق كالصاعقة…
كانت رؤيته وهو متوجّه نحو بوّابة المدرسة، بدرّاجته النّارية، كفيلة بأن تجعل أوصالي ترتعش من هيئته الضّخمة، إنّه الجلاّد الذي طالما تفنّن في تعذيب تلامذة القسم؛ قسم الشرطة أم قسم المدرسة لا أدري، خصوصا خلال حصّة الصّرف والإعراب، أو حصة التعذيب لا أدري، ورغم استيعابي المبكّر لقواعد اللّغة العربية،-وهو الأمر الذي أنقذني من بطش يده- إلاّ أنّ جهلي لِأُسُس التّعليم أو جهله لا أدري، جعلا الخوف من العقاب ملازما لي .هذا الخوف أثّر على نفسيّتي، و جعلني دائمةَ الصّمت، وهو ماكان يعزوه الجميع إلى عقلانيتي وهدوئي، رغم أنّها صفات لا تناسب البتّة طفلة صغيرة.
لم أرتَد ” المْسِيد ” ربّما كان هذا حظّي الأوفر، لكنّني ولجتُ باب المدرسة العمومية، في أوائل ثمانينات القرن الماضي وهي الفترة التي تزامنت مع الاحتقان الاجتماعي، نتيجة الأزمة الاقتصادية وما صاحبها من إضرابات واحتجاجات. كانت مرحلة الثمانينات، بما تحمله من مخاض سياسي أرخى بظلاله على المنظومة التّعليمية، وتفاقمت نتائجهُ البالغة على جيل بأكمله، إلى حدّ القُصور البالغ الذي رافق جيل السبعينات، رغم التغيّرات التي توالت فيما بعد، وعلى جميع المستويات.
كُنّا أكباشَ فِداء، لِمعلّمين يحملون زادا وفيرا من العُقد النّفسية نِتاج حمولة مرحلة تاريخية ، فكانت قطع الخراطيم البلاستيكية وسائلَ تّعذيب، تغذّي ساديةَ مَن تتلمذنا على أيديهم، لقد كانت المدرسة العمومية مرتعا خِصبا لِكلّ أشكال العنف النّفسي والجسدي، الذي عانى منه مُعظم جيلنا المهزوم، جيل السبعينات.
كنتُ في الصّف الأوّل عندما ردّدتُ النّشيد الوطني لأوّل مرة، تكرّر الأمر
ّ بعد ذلك كل صباح، وكبُر يقيني بأنّه مع كل نشيد، ستكبُر الأشياء الجميلة في وطني، وبشكل معقول يسمح لي بمعانقتِها…
كبُرتُ وعلمتُ ألاّ شيء يكبر غير العناء، لا شيء يرتفع غير البنيان والأسعار وأعداد الفقراء أمّا الأشياءالجميلة جدّا فإنّها لأولئك الذين تخلّفوا عن طابور الصّباح، الذي وقفتُ فيه بانتظام مع إشراقة كل يوم، وهدرتُ فيه صوتي الصّغير
الذي تغنّى طويلا، بالأغنيات الجميلة وأناشيد الوطن، بالكاد يردّد الآن سيرة الألم الصّامت، ويدي التي رفعتُها للتّلويح لِكلّ ماهو جميل، تكتفي بتطريز رِداءٍ على مقاس جِراحات جيل بأكمله…
أكتفي بالتّذكّر، وأتأسّف على طفولة لم تُزهر في وقتها المحدّد…
دأبتُ منذ سنّ صغيرة على قراءة الكتب، فقد كان أخي الأكبر أوّل من شجّعني عليها، بحيث كنت أقضي العطلة الصّيفية، في السّفر بصُحبة شخوص وأبطال الرّوايات والقصص لأشهر كُتّاب الأدب الكلاسيكي باللّغة العربية والفرنسية على حدّ سواء، وهو ما قاد هذا النّهم الجميل إلى بزوغ ملَكة الكتابة لديّ، فكان أوّل ما نُشر لي نصّ باللغة الفرنسية على إحدى صفحات “l’opinion des jeunes “.
أستحضر الآن هذا الشّعور بالانتشاء، في أول تجربة عفويٌة لي في الكتابة والنشر في سن الثانية عشرة من عمري، رغم وعيي اللاّحق بأن الكتابة مسؤوليّة جسيمة، وأنّها فعل مجنون، يلبس رداء الحكمة، ويتزيّن بالصدق…
كانت البيئة الأسريّة التي نشأتُ وترعرعت داخلها، بيئة محافظة شأنها شأن معظم الأسَر المغربية آنذاك، حيث ربّ الأسرةِ هو صاحب القرار الأول والأخير في تحديد تحرّكاتنا، سكناتِنا ومصائرَنا، لكنّه أيضا الرّجل المُقبل على الحياة والذّائع الصّيت بِكرمِه وشهامته، أمّا أمّي فكانت ربّة البيت التي لا تتعدّى حدودُ مملكتِها عتبة المنزل الذي يأوي سبع أبناء آخرين…
في سياق آخر، أستحضر إضراب 20 يونيو من سنة 1981 بسبب قرار رفع أسعار المواد الغذائية الأساسية، مما أشعل فتيل احتجاجات شعبيّة عارمة، تصدّت لها قواتُ الأمن بالقمع والعنف والاعتقالات، ومازلت أتذكّر الخوف الكبير الذي ساد البيت، وملامح الجنديّ الذي صوّب بندقيته بِنيّة التّهديد نحو نافذة الغرفة، التي تلصّصتُ مِن خلالها رفقةَ أمّي على منظر الشّارع المُرعِب حيث تنشُط حركة الاعتقال، ويتمّ تعنيف كل من تزامن مرورُه مع موجة الهيجان، في ذاك التّوقيت السّيّء في مدينة الدار البيضاء الصّاخبة.
ترسّخَ الشّعور لديّ بِعدم الأمان مرّة أخرى، لم تكن مجرّد صدمة فقط على المستوى النّفسي لِطفلة تفتح عينيها على الحياة ، بل ترسّخت أيضا، في الذّاكرة الجماعية
(La mémoire collective) فكانت لَبِنة أساسيّة تنحت شخصيّة المستقبل
هذا الإرث الجماعيّ- على المستوى النّفسي- ظلّ حاضرا إلى الآن، بحُمولتِه اللاّشعورية من خلال حدث تاريخي كنت شاهدةً عليه، بِحيث رافقني خلال مراحل النّماء، وساهم في تكوين هويّتي بأبعاد واعية، ستفتحُ باكرا باب التّساؤل على مِصراعيه، عن مَعالم مجتمع يعُجّ بالتّجاذُبات، ويُلزم فضولي المشروع بِفكّ شفرة رُموزه..
أعتقد أنّ جُذور تشكُّل الحسّ والذّوق الأدبيّ
تكمن في طفولتي المبكّرة، فخُصوصية المرحلة التّاريخيّة وسلامة المحيط الأُسري، قد عزّزت إلى حدّ كبير، إلى جانب عواملَ ذاتية أخرى، شغفي اللاّمحدود بِعوالم الكتابة المدهشة والإبداع .
تورية لغريب
Share this content: